يشهد لبنان في هذه الأيام، إضافة الى تأثيرات الخارج وتدخّلاته، ترجمةً لعدة تحوّلات حصلت في اجتماعه السياسي في العقدين الماضيين، وتجسيداً لأزمة نظامه وفلسفته التوافقية.
ويمكن الحديث حالياً عن ثلاثة عناوين كبرى، والانطلاق منها لمقاربة قضية الاصطفافات السياسية وما يحلّ بها بعد أفول مرحلة بدأت رسمياً في 14 شباط 2005 واستمرت حتى 7 حزيران 2009.
العنوان الأول هو انتقال تدريجي للقسمة الطائفية – السياسية "المركزية" (التي كانت منطلق الصيغة اللبنانية وأساس ميثاق ال1943 ومحور التعديلات المقترحة في اتفاق الطائف) من قسمة مسيحية مسلمة الى قسمة سنية شيعية. وهذا الانتقال له انعكاسات عميقة الأثر في الواقع السياسي، وهو يفسّر الكثير من الظواهر القائمة، وتتطلّب معالجته بحثاً هادئاً في مضاعفاته لضبطها ولمنع تكريسها، دستورياً على الأقل...
العنوان الثاني هو تجدّد الخلافات الداخلية حول موقع لبنان في منطقته ودوره بعد فصول مشابهة جرت في مراحل سابقة. وهي خلافات تأتي ككل مرّة في ظل متغيّرات إقليمية ودولية، وفي ظل تعبئة شعبية واسعة تهدّد "السلم الأهلي".
أما العنوان الثالث، فهو أزمة الديمقراطية التوافقية كما يظهّرها النظام ربطاً بإشكاليات العنوانين الأوّلين.

1- في القسمة الطائفية
عرفت نهاية الحرب والسنوات التي تلتها خروجاً للمسيحيين "الأقوياء" من صناعة القرار ومؤسساته. ذلك أن الإدارة السورية المستفيدة من الغطاءين الأميركي والعربي بعد حرب الخليج الثانية أعادت تشكيل السلطة مبعدة عنها القوى المسيحية ذات الشعبية الأكبر، من خلال النفي والسجن وقانون الانتخاب ومن خلال إضعاف رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وما يمثلانه في الفعل وفي الرمز المسيحيَّين.
وقد ترافق ذلك مع صعود كبير لقوتين متنافستين: الحريرية، والحزب إلهية.
الأولى، إقتصادية – مالية وإعمارية مدجّجة بالعلاقات العربية والدولية تحتاج للاستقرار ليتطوّر أداؤها ومشروعها.
والثانية، قتالية – عقيدية مرتبطة إيديولوجياً ولوجستياً بإيران وتحتاج الى إبقاء الحدود الجنوبية ساحة، وتوفّر لها الإدارة السورية في السياسة ما تحتاجه في العسكر: حرية الحركة وحرية القرار الحربي.
وقد فرضت دمشق تعايش القوّتين المذكورتين اللتين تحوّلتا أيضاً منطلقي علاقة الخارج بلبنان، قبل أن تبدأ في العام 1998 مسار تطويق للحريرية (لأسباب لبنانية ولأسباب داخلية سورية أيضاً) من خلال إيصال إميل لحود الى رئاسة الجمهورية ودعم مكوّن أمني مخابراتي في السلطة يخاصم الحريري ويصارعه داخل جميع المؤسسات، بما فيها التي يرؤس.
لكن التطورات بعد ذلك في الخارج والداخل، من الانكفاء الاسرائيلي عن الجنوب بعد احتلال دام 22 عاماً الى موت مسار التسوية في المنطقة الى نداء المطارنة (وما مثّله من موقف مسيحي هجومي في مواجهة الهيمنة السورية) وقيام لقاءي قرنة شهوان والمنبر الديمقراطي والمصالحة الدرزية المارونية إثر زيارة البطريرك الى الجبل، دفعت جميعها باتجاه تعديل موازين القوى لغير صالح النظام السوري ومساعيه. ثم جاءت حرب الخليج الثالثة عام 2003 (ووصول الأميركيين بمشروعهم "التغييري" الى المنطقة) لتنهي تفويض واشنطن لسوريا بإدارة لبنان. كما جاء البحث الفرنسي عن سبل مصالحة أميركا بعد خصامهما العراقي، لينتج القرار الأممي 1559.
وقد جعلت التطوّرات جميعها - في ظل رفض دمشق الإقرار بنتائجها – المواجهة في لبنان وعليه حتميّة. فجرى اغتيال رفيق الحريري بعد محاولة اغتيال مروان حمادة في رسالتين متتاليتين لإظهار مدى ذهاب النظام السوري بعيداً في دفاعه عن "موقعه" اللبناني. وأدّى ذلك الى انفجار إنتفاضة شعبية غير مسبوقة بحجم اصطفافاتها وبحيويتها، حشدت مئات الألوف من اللبنانيين، بعضهم بصفته المواطنية، وبعضهم بصفته جزءاً من كتل طائفية كبرى، يمكن القول إنها كانت بقيادة السنة وبشعارات المسيحيين وبإدارة وليد جنبلاط. وهي أدّت بموازاة الضغوط الأميركية والفرنسية والسعودية والمصرية والتركية الى خروج القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً على اجتياحها له.
في مواجهة هذه الانتفاضة الاستقلالية المثلّثة الأضلاع طائفياً، خرج أكثر الشيعة مصطفّين حول حزب الله ومعلنين الدعم لدمشق.
وعبّر خروجهم عن قرار حزب إلهي بالاندفاع نحو الداخل لمنع قيام سلطة سياسية ما بعد سورية تُعيد النظر في التموضع الإقليمي للبنان الذي كرّسته دمشق بما يمكن أن يهّدد حرية الحزب في حركته العسكرية جنوباً وفي ربطه الحدود بالمصالح الإيرانية من ناحية، وعن رغبة "جماعية" عندهم في حجز موقع أساسي في لبنان الاستقلال الثاني (ولو من خلفية معارضة له) بعد هامشية الموقع منذ الاستقلال الأول من ناحية أخرى.
ولم ينفع التحالف الرباعي في الانتخابات التي تلت 14 و8 آذار في ردم الهوّة بين المعسكرين وطمأنة الجميع الى موقعهم ودورهم في المرحلة الجديدة. بل هو فاقم من "المشكلة" المسيحية ومدّد ثانوية الموقع السياسي المسيحي في المعادلة الوطنية، خاصة مع العجز عن إسقاط إميل لحود وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد البريق الى الموقع ودوره المترنّح.
فكان انتقال العماد ميشال عون الى الحلف مع حزب الله (لأسباب مختلفة)، وما يعنيه الأمر من منح غطاء للموقف الشيعي المصرّ على إبقاء لبنان في الفلك الإيراني السوري، وكانت الأحداث والأهوال التي شهدنا، من الاغتيالات والاعتصامات وتعطيل المؤسسات وإحقاق الفراغ الدستوري والتجاذب حول المحكمة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مروراً بحرب تموز ومدلولاتها الإقليمية وتداعياتها مع انتصار حزب الله سياسياً فيها وسعيه الى توظيف ذلك في الداخل اللبناني (الذي أظهر هشاشته التوافقية خلالها)، وانتهاء بأحداث 7 أيار الدموية واتفاق الدوحة، لتعلن جميعها أن الازمة اللبنانية صارت عصيّة على الحل من دون غطاء إقليمي ودولي. وهو الغطاء الذي لا تبدو الأمور المتبدّلة متّجهة حتى الآن إليه.
ورغم انتخاب رئيس جمهورية العام الماضي وإجراء انتخابات نيابية جديدة منذ أشهر، فإن المعادلة اللبنانية الداخلية لم تتغير كثيراً لثلاثة أسباب:
الأول، أن الكتلة السنية (التي حسمت الانتخابات مباشرة في 36 مقعداً ورجّحت الكفة في 7 مقاعد إضافية) والكتلة الشيعية (التي حسمتها في 28 مقعداً ورجّحت الكفة في 12 مقعداً آخراً) ظهرتا من جديد كمحوري الاصطفافين الداخليّين حجماً ديمغرافياً ودوراً سياسياً وتعبوياً.
الثاني، أن مواقف العماد عون ونجاحه الانتخابي النسبي (رغم التراجع الكبير في حجم الكتلة المسيحية الناخبة له) أبقت الانقسام المسيحي على توازن بين المعسكرين. كما أنها أضعفت (ولو مؤقتاً) دور رئاسة الجمهورية من خلال التركيز على فكرة أن المشروعية المسيحية الشعبية خارجه، مما جعل المعركة السياسية الفعلية تبدو أكثر فأكثر سنية شيعية بغطاءين إقليميين متناحرين وبانقسام مسيحي تجاهها.
الثالث، أن النظام السوري لم يقتنع رغم ضعفه الشعبي لبنانياً ورغم هزيمة حلفائه في الانتخابات في مختلف الأقضية والمناطق غير الشيعية (باستثناء زغرتا، حيث الأسباب متعدّدة) أن دوره في لبنان لا يمكن أن يكون هيمنة أو تقاسم سلطة مع اللبنانيين، وأن "قاعدته الشعبية" الشيعية مرتبطة بحلفه بإيران وبمدى التزامه بهذا الحلف. وهو ما زال يحاول عرقلة المسار السياسي اللبناني لاستدراج عروض شراكة في المرحلة القادمة وانتزاع تطبيع رمزي معه، يُعطف على بعض الانفراجات في علاقته مع السعودية، هو التطبيع "الحريري".
بذلك، أُقفلت مرحلة من الصراع الداخلي ومن المعارك الإقليمية والدولية على عودة الى المربّع الأول: توازن رعب طائفي – أهلي (معادلته "الناخبون في 7 حزيران مقابل المسلّحين في 7 أيار")، ومراوحة سياسية وأمنية بانتظار التطوّرات الخارجية (تسويات أو مواجهات) وأثرها على سلاح حزب الله (وما يمثّله من تهديد استخدام في الداخل أو على الحدود الجنوبية)، من دون إسقاط حجم الإنجاز الوطني الذي حدث، والمتمثّل بإخراج القوات السورية من لبنان والصمود في معركة الاستقلال الثاني (رغم الضغط الأمني وحملات التهديد التي رافقته)...
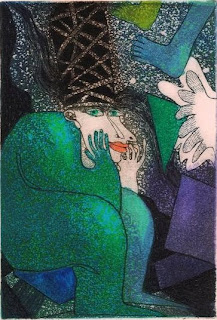
2- في موقع لبنان ودوره
منذ أزمة العام 1958 و"الميني - حرب أهلية" التي تخلّلتها، مروراً بأزمة العام 1969 ثم بالحرب الأهلية وانتهاءً بما يجري اليوم، يبدو جلياً عمق الخلاف الداخلي حول موقع لبنان ودوره في محيطه. ويبدو جلياً أيضاً اتخاذ هذا الخلاف الطابع الطائفي والمذهبي، مما يتيح له التسلّل الى مؤسسات الدولة نفسها وشّلها نتيجة تعدّد الرؤوس في النظام وانتمائها غالباً الى المحورين الخارجيين المتنابذين. فينتقل عندها الصراع الى الشارع، ويصبح الخارج تلقائياً محلّ التحكيم تهدئة أو دفعاً نحو المزيد من التصعيد.
وهذا يلغي المناعة الداخلية ويجعل البلاد على الدوام تحت رحمة الوضع الإقليمي، ويجمّد كل الأمور الأساسية بانتظار تبلور المعطيات الخارجية، واحتمالاتها اليوم كثيرة.
3- "الديمقراطية التوافقية" المأزومة
يبيّن التدقيق في بعض القضايا التي وسمت التجربة اللبنانية، بأزماتها وانفراجاتها، أن استلهام الديمقراطية التوافقية لم يكن على الدوام ناظماً للخيارات السياسية التي اتّخذها اللبنانيون، كما أن مؤسسات الدولة لم تنجح في العمل على الدوام بوحي من المبادئ التي خاض في تعريفها المفكر السياسي أرنت ليبهارت وغيره من منظرّي الديمقراطية التوافقية.
ويبيّن التدقيق أيضاً أن ما جرى عام 1943 من "نبذ متبادل" للمشروع العربي وللانتداب الغربي تأسيساً للاستقلال الوطني، وما تكرّر عام 1989 ولو بصيغة ثانية من تأكيد على عروبة لبنان (بديلاً عن "الوجه العربي")، وفي الوقت عينه على نهائية الكيان (بديلاً عن الأدبيات القومية المتخطية للحدود) لم يضمنا توافقات ثابتة يعود إليها اللبنانيون خشية الصدام حين تتباين وجهاتهم تجاه "الخارج".
لذلك، ها هو لبنان مجدداً جزء من منظومة صراعات إقليمية، ليس من خلال الدولة فيه، بل من خلال قوة أهلية مسلحة تمنع الدولة (ومن داخل مؤسساتها) من القدرة على التصرف أو التموضع، وتجعل كل رفض لخياراتها الخارجية يجاهر به لبنانيون آخرون صداماً مع جمهورها في الداخل.
وإن عطفنا على هذه المشكلة تجاه "الخارج" أزمة الأحجام داخل السلطة وسعي كل طرف للاستفادة من ظروف داخلية وخارجية يعتبرها لصالحه لتوسيع حجمه وحصّته بعيداً عن القبول بتوازنات التوافقية السابقة على الظروف التي تعنيه، وصلنا الى وصف واقعنا بالمعضلة وبالحالة المتطلّبة إصلاحاً جذرياً وتغييراً لصيغ الحكم لا تتيحه الأوضاع الحالية ولا توازناتها.
إنتهاء مرحلة قد لا يعني انتهاء كامل تحالفاتها
إذا كانت هذه العناوين – وهي قديمة متجددة - هي أبرز معالم التأزم اليوم، وإذا كان الحسم لصالح أحد المعسكرين الداخليين متعذّراً، وإذا كانت مرحلة السنوات الاربع الأخيرة قد انتهت على تعادل (فبقيت أكثر قضاياها معلّقة)، فإن البديهي يصبح البحث عن تخفيف حدّة الاصطفافات وخلط الأوراق للخروج من التوتر الخطير.
لكن البداهة هذه ليست بالسهولة المفترضة، ولا بقابلية التحقّق السريعة.
ولنا في حركة وليد جنبلاط دليل على صعوبة خلق دينامية جديدة في ظل صلابة الاصطفافين الشيعي والسنّي خلف زعامتي حزب الله وسعد الحريري.
وإذا كانت قراءة جنبلاط للتبدّلات الخارجية من جهة، ورغبته تخفيف التوتّر مع حزب الله بعد الاشتباكات الدموية في الجبل وبيروت وقبل ما قد يصدر عن المحقق الدولي في جريمة اغتيال الحريري من جهة ثانية، إضافة الى خشيته على زعامته الترابية territorial نتيجة وضع جبل لبنان الجنوبي وما ظهر فيه من تنافس على المقاعد بين الحلفاء عشية الانتخابات النيابية، هي ما أملت عليه الخروج من 14 آذار (والإبقاء على علاقة متينة بتيار المستقبل حصراً)، فإن وجهته الوسطية التي يعتقد أن نبيه بري يستطيع التواصل معها لن تفيد في كسر حدّة الاصطفافين. بل أكثر ما يمكنها فعله هو تأمين قنوات اتّصال بينهما (وربما التنسيق مع رئاسة الجمهورية للعب دور ترجيحي عند المنعطفات المهمة).
إنطلاقاً من الصعوبة هذه إذن، يبدو لنا أن المرحلة المقبلة لن تشهد تغييرات داخلية كبيرة قبل نضوج الظروف الخارجية. فتحالف تيار المستقبل مع القوات اللبنانية يبدو مستمراً، في وقت لن يبتعد حزب الكتائب كثيراً عنه، وإن كان يحاول التمايز في عدد من الملفات المسيحية أملاً في بعض التوسيع لقاعدته الشعبية ولحضوره الجغرافي.
وفي المقابل، لا مبرّر موضوعياً يشير الى احتمال انفكاك التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وسيبقى نبيه بري بدوره في هذا التحالف مع هامش يسمح له (كما ذكرنا) بالتواصل عبر وليد جنبلاط مع التحالف المقابل، كما سيبقى حزب الطاشناق قريباً الى هذا التحالف ولكن من دون تماهٍ معه (خاصة إن تباين موقفه مع موقف رئيس الجمهورية).
أما سائر القوى والهيئات والشخصيات (في 14 آذار، وليس في 8 لأن الأخيرة أشد مركزية في علاقتها بمرجعيتها الإقليمية)، فلا تبدو رغم جدّية بعضها، قادرة اليوم، على تشكيل اصطفاف ثالث فاعل، أو حتى التأثير عميقاً في الاصطفافين. لعل بعض الوقت يتيح لها إعادة قراءة المشهد العام والبحث في سبل التعاطي المستقبلي معه...
زياد ماجد